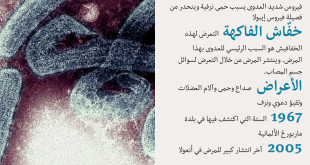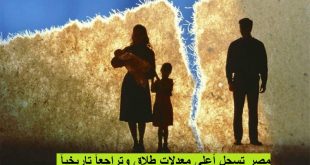السيسي باع القضية الفلسطينية من أجل مصالحه الشخصية وسر زيارة رئيس الشباك السرية الى مصر.. الأربعاء 16 أكتوبر 2024م.. رغم حبسهم 6 سنوات بقضية “العمليات النوعية” اليوم أولى جلسات محاكمة البر وغزلان
السيسي باع القضية الفلسطينية من أجل مصالحه الشخصية وسر زيارة رئيس الشباك السرية الى مصر.. الأربعاء 16 أكتوبر 2024م.. رغم حبسهم 6 سنوات بقضية “العمليات النوعية” اليوم أولى جلسات محاكمة البر وغزلان
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إقالة عباس كامل من رئاسة المخابرات العامة المصرية
مصر هي أم عباس .. يا حسرتك يا أم عباس
أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارًا له، منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص له.
كما أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة.
وكان كامل (62 عاما) هو الرئيس الـ26 للمخابرات العامة، أحد الأجهزة التي يطلق عليها صفة “سيادية” في مصر مثل جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني “أمن الدولة سابقا”.
وشغل كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ أن كان السيسي مديرا للمخابرات الحربية، ثم وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس محمد مرسي الذي أعلن الجيش عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، ثم شغل كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ انتخابه رئيسا في 2014.
وظهر عباس كامل في معظم لقاءات وجولات السيسي حتى الاجتماعات السياسية والأمنية والاقتصادية والخارجية، حتى أنه تم تسميته بـ”ظل الرئيس”، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لترسيب مكالمات سرية منسوبة له.
ظهر اسمه لأول مرة في أكتوبر 2013 أثناء حديث عبد الفتاح السيسي “وزير الدفاع آنذاك” في حوار صحافي عندما سأل الصحافي المحاور عن عدد قتلى فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة فأجاب: “اسأل عباس”.
*الحرية المسلوبة: نورهان دراز في قفص الظلم والاعتقال
في زخم الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تعصف بمصر، تبرز قصة امرأة أُسكت صوتها وأُودعت خلف القضبان بسبب كلمات كتبتها على صفحات الإنترنت،
كلمات كانت تلامس الحقيقة وواقع الناس المعيش، تلك هي نورهان أحمد دراز، التي قررت أن تفتح فمها للحديث عن ما لا يجرؤ الكثيرون على قوله.
ففي الخامس من أغسطس، اقتحمت قوات الأمن منزلها الكائن في حدائق الأهرام، لتخطفها من بين أفراد أسرتها، دون أن تترك لهم أي فرصة لفهم ما يحدث.
كانت لحظة مرعبة، إذ تحوّل هدوء الليل إلى فوضى، وعادت سيدة متقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، إلى ماضي عاصف تذكره، لكن هذه المرة تحت أعين رجال الأمن الذين لم يرحموا نداءاتها.
12 يوماً من الاختفاء القسري مرت عليها كالأبد، حيث لم يعرف أحد مكانها، وتاهت تفاصيل أيامها في ظلام حالك.
وفي يوم 17 أغسطس، ظهرت مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، لكن لم يكن ذلك ظهراً عادياً. كان تعبير وجهها، الذي كان يُظهر آثار الخوف والتعب، أكثر صراحة من أي كلام.
استجوبت وهي محاطة بسياج من الإهمال والإذلال، فقط لأنها أعربت عن رأيها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
اتهامات تلاحقها كالأشباح، انضمام إلى جماعة منشأة مخالفة للقانون، تلقي تمويلات أجنبية، نشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ.
كانت تلك التهم كافية لتسليط الضوء على الحالة الحرجة التي تعيشها البلاد، ولكنها كادت تُكلفها حريتها.
وها هي الآن، رغم معاناتها الصحية المتدهورة، تجلس في قاعة المحكمة عبر الفيديو كونفرانس، كأنها حبيسة داخل شاشة تعكس حالتها، لكن لا مجال للحديث عن آلامها، ولا مجال لمطالبتها بحقوقها.
كان تجديد حبسها مجرد إجراء روتيني، بينما حُرمت من الأدوية التي تعاني من عدم دخولها إليها، وسط رفض قاطع لإدارة السجن السماح بدخول البطاطين التي تحتاجها في ظل الظروف القاسية.
قصتها ليست مجرد واقعة عابرة في زمن مليء بالقصص المأساوية، بل هي تمثل رمزًا لملايين الأشخاص الذين يُسكت صوتهم بسبب موقفهم من السياسة أو بسبب رغبتهم في التغيير.
تعكس معاناة نورهان دراز التحديات التي تواجهها النساء في السجون، اللواتي لا يسعفهن أحد، وكأن النظام لا يرى سوى سطور دون أن يتبين ما بين تلك السطور من ألم ومعاناة.
تتحدث التقارير عن استمرار الضغوطات على المتهمين بالتعبير عن آرائهم، وتزداد المخاوف مع تجدد قمع الأصوات الحرة في المجتمع،
حيث تبرز حكاية دراز كقصة إنسانية مأسوية تتقاطع مع قضايا أكبر، تتعلق بحقوق الإنسان والحرية.
إن اعتقال نورهان أحمد دراز ليس مجرد حادثة شخصية، بل هو مثال صارخ على معاناة كل من يجرؤ على التفكير بجرأة، وعلى كل من يحمل في قلبه هموم الوطن.
إن تدهور حالتها الصحية يُلقي بظلاله على تلك الأصوات التي تحاول أن تُسمع، لكنه لن يقضي على إيمانها بحقوقها وحق الآخرين في التعبير.
في هذا السياق، يجب على المجتمع أن يستيقظ ويتحرك. يجب أن تُعطى الأصوات التي تُطالب بالعدالة الفرصة للتعبير عن آرائها، بل يجب أن تُحمى.
ومن هنا، تُصبح قصة نورهان دراز حكاية تروى في زوايا الفصول، لتكون منارة تُضيء الطريق لكل من يسعى للحرية في عالم مُظلم.
هي ليست مجرد قصة امرأة محبوسة، بل هي سرد مليء بالأمل والصمود، مواجهة الظلم بعباءة من الشجاعة،
تحمل بين طياتها صدى الآلام التي يعيشها الكثيرون، وتدعو الجميع لفتح أعينهم على الحقائق التي تحاول السلطات طمسها.
لذا، تستمر الحكاية، تستمر المعاناة، وتبقى نورهان دراز رمزًا لحقبة لم تتقبل بعد صوت الحق،
بينما لا تزال عيون الأمل تتطلع نحو غدٍ أفضل، قد يحمل في طياته الحرية والسلام، وسط أمواج من التحديات والصعوبات.
* رغم حبسهم 6 سنوات بقضية “العمليات النوعية” اليوم أولى جلسات محاكمة البر وغزلان
حددت محكمة استئناف القاهرة بسلطة الانقلاب، جلسة عاجلة، اليوم الأربعاء، لنظر أولى جلسات المحاكمة الهزلية لعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عبد الرحمن عبد الحميد البر، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومتحدث باسم الجماعة وعضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة الزقازيق محمود سيد غزلان، و39 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “لجان العمليات النوعية بالنزهة”.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية في تصريحات صحفية أن الموجهة لهم اتهامات في القضية عدد محدود منهم خارج البلاد، ومعظمهم معتقل ومحبوس على ذمة القضية طوال ست سنوات بالمخالفة للقانون المصري الذي حدد مدة عامين فقط حداً أقصى لفترة الحبس الاحتياطي، وتم تقديم بلاغات ومذكرات للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا وقاضي المعارضات بهذا الشأن ولم يتم النظر فيها.
وأضافت هيئة الدفاع أنهم لم يُمكّنوا طوال سنوات التحقيق التي تجاوزت ست سنوات في القضية من الاطلاع على الاتهامات أو معرفة الأدلة التي تدين موكليهم، مؤكدة أنها كلها تحريات مكتبية من قبل السلطات الأمنية التي في خصومة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأحالتهم نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب، على ذمة القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، وادعت فيها استهدافهم وتخطيطهم لتفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة، ضمن العمليات النوعية للجماعة.
وادعت النيابة “توليهم وقيادتهم جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات”.
كما اتهمتهم النيابة العامة “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، والتخريب عمدا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى”.
* تدوير 18 معتقلا بعضهم أخفي لشهور .. وتجديد حبس 8 آخرين 45 يوما
كشف مصدر حقوقي عن تدوير 18 معتقلا بنيابات الشرقية من خلال المحضرين المجمعين 157 و156 وهي نوعية من المحاضر، دأب على إعدادها “للنيابات” جهاز الأمن الوطني بالمحافظة تضم من كل مركز معتقل أو أكثر لتبرير التدوير (تلفيق قضية جديدة لمعتقل).
وفي المحضر المجمع 157 وكان بشأن تدوير معتقلين بمركز ديرب نجم وكان ل8 معتقلين وهم:
عاصم محمد عبدالمنعم فياض، ديرب نجم، ظهر بعجد اخفاء قسري 95 يوما.
عادل محمد السيد مصيلحي، ههيا، ظهر بعد اخفاء قسري 125 يوما.
حذيفة أحمد أحمد عبدالرحمن جاد، أبو حماد، ظهر بعد اخفاء 120 يوما.
عمر عبدالرحمن هشام علي قابيل، منيا القمح، ظهر بعد اخفاء 90 يوما.
إبراهيم محمد محمود عباس البري، مشتول السوق، تدويره من المحضر المجمع رقم 66.
عبدالمنعم السيد عبدالمنعم، مشتول السوق، تدويره من المحضر المجمع رقم 66.
أسامة رفاعي خليل، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع رقم 66.
وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.
وأمام نيابة الزقازيق الكلية وزعت المحضر رقم 156 وصل إجمالي المعتقلين علي ذمة المحضر 10 معتقلين وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثان الزقازيق.
والمعتقلون العشرة هم:
محمد فوزي محمد، الإبراهيمية، تدويره من المحضر المجمع رقم 62.
رأفت عثمان محمد، الإبراهيمية، تدويره من المحضر المجمع رقم 62.
حمدي زكي دحروج، بلبيس، تدويره من المحضر المجمع رقم 52.
بكري عبدالعزيز بكري، العاشر من رمضان، تدويره من المحضر المجمع رقم 74.
جمال الهادي عبد العزيز، منيا القمح.
يحيى بيومي، بلبيس.
رأفت فاروق عبدالحميد، منيا القمح، تدويره من المحضر المجمع رقم 74.
رمضان حسن محمد، العاشر من رمضان، تدويره من المحضر المجمع رقم 74.
عبدالله السيد عبدالفتاح، تدويره من المحضر المجمع رقم 74.
ناصر يوسف محمد، بلبيس، تدويره من المحضر المجمع رقم 74.
تجديد حبس 45 يوما
ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا عن تجديد حبس 8 متهمين على ذمة قضايا مختلفة وتحديد التدابير للآخر لمدة 45 يوما.
حيث قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس 8 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة.
ومن بين المتهمين: رضا محروس علي، ومحمود خميس قرني وذلك في القضية رقم 1935 لسنة 2021حصر تحقيق أمن دولة عليا.
والمتهمان : ربيع عبدالفتاح إسماعيل، خالد محمود سامي، وذلك في القضية رقم 2380 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وأحمد محمد صابر عمران، وعبداللاه محمد محمد جبر .. في القضية رقم 626 لسنة 2021حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ومحمود السيد محمود بشار، في القضية رقم 1983 لسنة 2021حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وأحمد جميل عبدالصادق عمار، وذلك في القضية رقم 41 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ومن جانب مواز جددت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، التدبير الإحترازي 45 يوما للمتهم محمد خالد عبدالحميد وهو معتقل على ذمة القضية رقم 3569 لسنة 2024جنح مركز الجيزة .
* رغم محكوميته 30 يومًا.. وفاة سجين بالالتهاب السحائي بقسم شرطة أول طنطا
تداول عدد من النشطاء خبر وفاة أحد النزلاء وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية، بسبب التهاب رئوي أصيب به داخل القسم، ولم يتم علاجه.
النزيل المشار إليه (محكوم عليه في قضية “تبديد” بالحبس لمدة شهر وبدأ حبسه في 18 /9/ 2024 بمركز إصلاح وتأهيل قسم أول طنطا)، وقد شعر النزيل بحالة إعياء وتم نقله إلى أحد مستشفيات الحميات
بالغربية بعد تدهور حالته، وتوفي قبل الوصول، فيما تشير أنباء إلى وفاة آخرين في نفس القسم بالتهاب رئوي أيضًا.
في يوم الأحد الماضي، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن “المعتقل السابق أحمد عبد الله أبو القاسم (32 عامًا) توفي بعد سقوطه مغشيًا عليه ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة بمنطقة
البيطار بالعجمي في الإسكندرية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد خروجه مباشرة من حضور المتابعة الدورية غير الرسمية المفروضة عليه بأمر مباشر من قبل الأمن الوطني بالمحافظة.”
ومنذ أيام، وثقت منظمات حقوقية، مثل مركز الشهاب لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي مجدي محمد عبد الله محمود في مستشفى سجن المنيا، حيث تدهورت حالته
الصحية نتيجة الظروف القاسية وسوء الرعاية الطبية التي يعاني منها في السجن.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد 11 حالة وفاة في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال شهر يونيو الماضي، أما أسباب وفيات السجناء، فمعظمها نتيجة الإهمال الطبي
المتعمّد أو ارتفاع درجات الحرارة أو اكتظاظ غرف الاحتجاز، وذلك من ضمن 295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان في يونيو.
وفي شهر يوليو، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ستة معتقلين لقوا حتفهم خلال أسبوع داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية.
حيث توفي محمد فاروق حسين، البالغ من العمر 49 عامًا، وهو سادس معتقل يموت أثناء الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية وسط درجات الحرارة المرتفعة والازدحام.
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن حسين كان يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس منذ عدة أسابيع، وقد طلب مرارًا وتكرارًا عرضه على طبيب مختص أو نقله إلى المستشفى، لكن سلطات
مركز الاحتجاز رفضت طلبه، وتم نقله أخيراً إلى مستشفى الزقازيق، حيث توفي الاثنين الماضي.
وتأتي وفاته بعد وفاة خمسة معتقلين جنائيين آخرين في المركز، جميعهم توفوا خلال 48 ساعة، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
من جهته، قال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، في تصريحات سابقة: “تمثل هذه الوفيات نموذجًا مصغرًا للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة
في مصر، وسط غياب كامل للرقابة والتفتيش من قبل السلطات المسؤولة.”
ويعاني كافة المعتقلين من اكتظاظ شديد، حيث تصل نسبة الإشغال في بعض الأماكن إلى 300% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية لغرف الاحتجاز.
وتسلط تلك الجرائم بحق المسجونين الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظروف، وضمان الرقابة المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
* سرطان الثدي يُفاقم معاناة المعتقلات السياسيات بسجون السيسي
تعاني عشرات السجينات في سجون المنقلب السفاح السيسي من السرطان، ولا سيّما سرطان الثدي، دون الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وكان شهر أكتوبر قد خُصّص للتوعية بمرض سرطان الثدي الذي يُعَدّ أكثر السرطانات انتشارًا بين النساء، بناءً على مبادرة عالمية تحت عنوان “أكتوبر الوردي” أُطلقت في هذا الشهر من عام 2006.
وبعيداً عن فعاليات “أكتوبر الوردي” في مصر، تتزايد الاستغاثات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن النساء المصابات بالسرطان في السجون المصرية ومقار الاحتجاز المختلفة بالبلاد، مع التنديد بالإهمال الطبي الجسيم الذي يطالهن.
وقد دعت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس إلى الإفراج الفوري عن رضوى ياسر سيد محمد برعي، البالغة من العمر 22 عامًا، التي تقبع في السجن منذ 21 أغسطس 2021، على ذمّة القضية رقم 2976 لسنة 2021 المعروفة إعلاميًا بقضية “جروب مطبخنا”، خصوصاً بعد تدهور صحتها على خلفية إصابتها بسرطان الثدي.
وتعاني رضوى، وفقاً للجنة العدالة، من “تدهور شديد في حالتها الصحية نتيجة إصابتها بسرطان الثدي”، الأمر الذي “يستدعي خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي بشكل عاجل وإجراء الجراحات الضرورية للحفاظ على حياتها”.
يُذكر أنّ رضوى كانت، قبل احتجازها، ناشطة مجتمعية وحقوقية عُرفت بمشاركتها في دعم المحتاجين، وقد وسّعت نشاطها ليشمل مساعدة أسر السجناء السياسيين بعد إلقاء القبض على والدها سيد محمد السيد، فهو أمضى ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمّة قضية “كتائب حلوان” قبل تبرئته أخيرًا، بحسب لجنة العدالة.
وفي الفترة التي سُجن فيها والدها، عَملت رضوى على توفير الدعم المادي والمعنوي لأسر السجناء، من خلال تحضير الأطعمة والزيارات، ومساعدة الجمعيات الخيرية في تنظيم الدعم المادي والمعنوي لهذه الأسر، وفقاً لما بيّنته لجنة العدالة التي حذّرت من أنّ “حالة رضوى ياسر الصحية تشكّل خطرًا جسيمًا على حياتها إذا لم يتمّ الإفراج عنها سريعاً لتلقّي العلاج اللازم.”
وأضافت اللجنة أنّ سرطان الثدي “يُعَدّ من الأمراض الخطرة التي تتطلب رعاية طبية متواصلة وعلاجًا كيميائيًا منتظمًا، وهو أمر يصعب توفيره في ظروف الاحتجاز غير الملائمة”.
وشدّدت اللجنة الحقوقية على أنّ استمرار احتجاز رضوى، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالتها، يمثّل “انتهاكًا صريحًا لحقّها في الحياة والصحة، ويزيد من خطر تدهور حالتها بشكل قد يكون غير قابل للتدارك.”
وحمّلت لجنة العدالة “السلطات المصرية، ممثلة بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على حياة رضوى ياسر”، مطالبةً تلك الجهات بـ”الالتزام بواجباتها القانونية والإنسانية تجاه السجناء، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية الضرورية لهم.”
وأضافت لجنة العدالة أنّ الإفراج الفوري عن رضوى أمر ضروري، وذلك من أجل تمكينها من تلقّي العلاج اللازم لمواجهة سرطان الثدي الذي تعاني منه، مع التأكيد على أنّ “التأخير في اتخاذ هذا الإجراء قد يُعرّض حياتها للخطر، ويُعَدّ خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية.”
في سياق متصل، أطلقت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” أخيرًا حملة “أرواح سجينات في خطر”، للإضاءة على حالات سجينات يعانين من مرض سرطان الثدي أو من “أورام الثدي” بحسب تعبير المنظمة، وهي تعرّف عن نفسها بأنها تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية، وتعمل على الحدّ من الانتهاكات ضدّ النساء والأطفال خصوصًا.
وقد جاءت الحملة لتسلّط الضوء على السجينات السياسيات المريضات في السجون المصرية، إذ رصدت المنظمة الحقوقية ما يزيد عن 32 سجينة سياسية مريضة في السجون، علماً أنّ هؤلاء يعانين من 24 مرضًا أو مشكلة صحية، وسط ظروف احتجاز سيئة ورعاية صحية متردية.
وتناولت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” في حملتها عشر نساء يعانين من أورام سرطانية مختلفة في السجون المصرية، خصوصًا من سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعًا.
بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع من بين هؤلاء النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي في السجون المصرية، وقد أُلقي القبض عليها في مارس 2016، وأُدرجت على ذمّة القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً بقضية “اغتيال النائب العام”.
بدورها، تعاني ناهد نبيل حافظ حسن من سرطان الثدي في السجون، بحسب المنظمة التي توضح أنّ إلقاء القبض عليها جرى في 28 فبراير 2020، وهي ما زالت تعاني، فيما هي محبوسة على ذمّة القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
*”عريضة للتوقيع” منظمات ونشطاء يتضامنون مع أهالي جزيرة الوراق ويطالبون برفع الحصار
أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء تضامنهم مع أهالي جزيرة الوراق، مؤكدين دعمهم لمطالب العائلات التي ترفض إخلاء الجزيرة، متمسكين بحقهم في الاحتفاظ بمنازلهم وأراضيهم، وحقهم في إعادة تملك منازلهم بعد تطوير الجزيرة، بالإضافة إلى مطالبتهم باستكمال علاج المصابين في مواجهات سابقة مع قوات الأمن التي خلفت إصابات دائمة لبعض السكان، ورفع الحصار المفروض على الجزيرة وعودة حركة المعديات إلى طبيعتها.
جاء ذلك في اجتماع عُقد يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث طالب الموقعون الحكومة المصرية بإنهاء الحصار الأمني الذي تفرضه على أهالي الجزيرة منذ عام 2017، والذي أدى إلى استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نحو 71% من أراضي الجزيرة بالإكراه.
وأكد الموقعون أن الجزيرة تعرضت منذ 16 يوليو 2017 لاقتحامات متكررة من قوات الشرطة بهدف إخلاء الأهالي من منازلهم بالقوة، مما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة العديد منهم، ولا يزال عدد من الأهالي قيد الحبس بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأشار الموقعون إلى أن تجريف الأراضي الزراعية في الجزيرة يعد تهديدًا لاستدامة البيئة الطبيعية، حيث يتم تدمير مصادر العيش الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية، مما يؤثر على الأمن الغذائي للسكان. وأضاف الموقعون أن الحكومة بررت هذه الإجراءات بضرورة إخلاء الجزيرة لتنفيذ مشروع “مدينة حورس”، الذي يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري عالمي يتضمن أبراجًا سكنية وتجارية وفنادق. ونتيجة لذلك، تناقصت الأراضي الزراعية في الجزيرة بشكل ملحوظ.
وأكدت المنظمات أن هذه السياسات الحكومية تنتهك الدستور المصري، الذي يجرم التهجير القسري، وتخالف الاتفاقيات الدولية التي تلزم الحكومات بالتفاوض مع السكان المحليين قبل الشروع في أي مشروع تنموي. وشددوا على أن الحصار الأمني المفروض على الجزيرة يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق السكان في الحياة والسلامة الشخصية، مما دفع الأهالي لتنظيم مظاهرات واحتجاجات مستمرة.
وطالب الموقعون بضرورة البحث عن بدائل للإخلاء بالتشاور مع الأهالي، وتفادي قرارات الإخلاء القسري، مؤكدين على حق السكان في الطعن القانوني على هذه القرارات. كما شددوا على أهمية الالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم. وأكد الموقعون ضرورة توفير الدعم القانوني والمساعدة اللازمة للمتضررين من قرارات التهجير، وضمان إجراء مشاورات حقيقية مع المتضررين لحماية حقوقهم.
*السيسي باع القضية الفلسطينية من أجل مصالحه الشخصية وسر زيارة رئيس الشباك السرية الى مصر
يثير الكشف عن الزيارة السرية التي قام بها رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، إلى القاهرة في الأحد الماضي، تساؤلات جديدة حول دور رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، وما إذا كانت هناك دوافع شخصية وراء مواقفه تجاه غزة ومسار المفاوضات المعطلة.
وفقاً لموقع “واللا” العبري، ناقش رونين بار مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل عدة ملفات حساسة، أبرزها الجمود الذي تواجهه مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأوضاع حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وهما نقطتان محورتان في الصراع الجاري بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة.
محور فيلادلفيا ومعبر رفح: ساحة صراع جديدةيمثل محور فيلادلفيا، الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر، واحدًا من الملفات الأكثر تعقيدًا في المحادثات بين إسرائيل ومصر. فقد بسطت قوات الاحتلال سيطرتها على المحور منذ شهور، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة إغلاق معبر رفح، المنفذ البري الوحيد الذي يربط القطاع مع العالم الخارجي عبر الأراضي المصرية.
الاحتلال الإسرائيلي نشر مؤخرًا أبراج مراقبة وكاميرات على طول محور فيلادلفيا، ما يزيد من تأكيد تمسكه بهذا الموقع الاستراتيجي.
وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر رفح، مما يزيد الضغط على سكان غزة ويعرقل أي تقدم في المفاوضات الرامية لإيجاد حل وسط بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال.
السيسي ودوره في المفاوضات: أين المصلحة المصرية؟
منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، يحاول الوسطاء المصريون لعب دور حاسم في تحريك المفاوضات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال المفاوضات تواجه طريقًا مسدودًا، خصوصًا في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى وفتح معبر رفح.
لكن هنا تتصاعد التساؤلات حول الدور الحقيقي للسيسي في هذا الملف. فهل يدفع السيسي باتجاه حل الأزمة لمصلحة الشعب الفلسطيني، أم أن هناك مصالح مصرية خاصة – وربما شخصية – هي التي تسيطر على قراراته؟
لقاءات سرية وتسريبات: ما بين المعلن والخفي
زيارة رونين بار إلى القاهرة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها زيارة مشتركة لرئيس الشاباك ورئيس الموساد في أغسطس، وهو ما يشير إلى أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل قد شهد تطورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة.
وهذه اللقاءات تأتي في وقت حساس جدًا، حيث تواجه مصر ضغوطًا إقليمية ودولية للتوسط في الأزمة، بينما تشكك أطراف عديدة في نوايا السيسي الحقيقية. ما يدعو للتساؤل هو أن هذه الزيارات تتزامن مع تصريحات ومواقف رسمية من الجانب الإسرائيلي تشير إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، يسعى لتمديد فترة الحرب على غزة وتعطيل أي جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
ويرى بعض المحللين الإسرائيليين أن نتنياهو يستخدم هذه الحرب كورقة لضمان استمراره في السلطة وتجنب المحاكمة على خلفية الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.
هل السيسي جزء من المشكلة؟
تشير بعض الأصوات المعارضة إلى أن السيسى قد يكون جزءًا من التعقيد الحالي، بدلًا من كونه جزءًا من الحل. فالسيسي، الذي يعتمد في جزء كبير من شرعيته السياسية على استقرار علاقاته مع القوى الدولية والإقليمية، قد يجد في استمرار الحرب فرصة لتعزيز موقعه الإقليمي والتأكيد على دوره كوسيط رئيسي في الأزمة.
لكن على الجانب الآخر، يتهمه منتقدوه بأنه يساوم على القضية الفلسطينية مقابل الحفاظ على دعم إقليمي ودولي، خصوصًا من الولايات المتحدة وإسرائيل. فالسيسي يعتمد على دعم هذه الأطراف، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، مما يضعه في موقف صعب بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأمن القومي المصري.
نتنياهو والعقبات أمام الحلول
من جانب آخر، يشير مراقبون إلى أن بنيامين نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا ومعبر رفح كورقة ضغط لإبقاء الأوضاع في غزة مشتعلة. فمن خلال السيطرة على هذه النقاط الحساسة، يضمن نتنياهو استمرار الحصار على القطاع وتعطيل أي مساعي لوقف إطلاق النار.
ورغم محاولات الوسطاء المصريين دفع العملية التفاوضية، إلا أن نتنياهو يبدو مصممًا على مواصلة الحرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، مستغلًا الوضع الأمني المتدهور للبقاء في السلطة.
مصالح متبادلة على حساب القضية الفلسطينية؟
في ظل هذه التعقيدات، تتصاعد الشكوك حول ما إذا كان السيسي يسعى حقًا إلى حل الأزمة الفلسطينية أم أنه يستخدمها كورقة تفاوضية لتعزيز مصالحه الشخصية والإقليمية. فالتعاون الأمني المكثف بين مصر وإسرائيل في الآونة الأخيرة، إلى جانب اللقاءات السرية التي يجريها المسؤولون الإسرائيليون مع نظرائهم المصريين، يعزز من هذا الشك.
ورغم الجهود العلنية التي تبذلها مصر لتحريك المفاوضات، يبدو أن هناك توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل وضمان الاستقرار الداخلي والإقليمي.
ولكن في نهاية المطاف، يظل السؤال المطروح: هل باتت القضية الفلسطينية مجرد ورقة للمساومة بين القادة، في ظل معاناة مستمرة للشعب الفلسطيني الذي يدفع الثمن الأكبر؟
* رغم نفي مدبولي الحكومة تعلن جدولا زمنيا لبيع 20 مطارا وبنكا
رغم الادعاءات المتكررة من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي وأعضاء حكومته بعدم وجود نية لبيع المطارات سواء لجهات مصرية أو أجنبية، أكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف مدبولي في تصريحاته أمس خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.”.
وكشفت مصادر لجريدة عربية أن مؤسسة التمويل الدولية انتهت من الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح إدارة وتشغيل 20 مطارا في مصر أمام القطاع الخاص، منها 4 مطارات جديدة، وتمتلك مصر 23 مطارًا، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي الأكبر والرئيسي في البلاد.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية، استشاري برنامج الطروحات الحكومية المصرية، قد أوصت بأن يشمل برنامج الطروحات المطارات المصرية كأصول يمكن تطويرها والاستفادة منها وتعظيمها، عبر طرح إدارتها
وتشغيلها وتطويرها على القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المطارات.
وبحسب المصادر، فإن المطارات المطروحة تشمل 4 مطارات جديدة تم تطويرها خلال السنوات التسع الماضية، وذلك من إجمالي 20 مطارًا ضمن خطة الطروحات.
وأضافت المصادر أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت بالفعل الدراسة الفنية لطرح هذه المطارات، وتم تسليم الحكومة المصرية الجدول الزمني لخطة الطرح.
* مشروع ” ربط فيكتوريا ” إرث مرسى هل يكون طوق النجاة الأخير لعلاقة مصر بالدول الافريقية ؟
شهدت مصر في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع التنموية التي تم الترويج لها على أنها ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ومن أبرزها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط. هذا المشروع، الذي وضع حجر أساسه الرئيس الراحل محمد مرسي، يبدو اليوم وكأنه أمل جديد للعديد من الدول الأفريقية، لكنه يطرح أيضًا تساؤلات حول قدرة النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي على تحقيق هذا الحلم.
مشروع مرسي: رؤى طموحة لمستقبل مشترك
عندما أُعلن عن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط في عهد محمد مرسي، كانت الفكرة تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول حوض النيل.
هذا المشروع كان يُعتبر خطوة حيوية لتعزيز الروابط بين الدول الأفريقية وتسهيل حركة التجارة من وسط أفريقيا إلى الأسواق العالمية. مرسي كان قد أظهر اهتمامًا واضحًا بتعزيز العلاقات الأفريقية، وعُرف عنه حرصه على وضع مصالح مصر في المقدمة.
تتحدث الدراسات عن أهمية هذا المشروع الذي يُعتبر “شريان حياة” للتجارة الأفريقية، حيث يربط العديد من الدول مثل كينيا وأوغندا والسودان ومصر.
لكن في ظل حكم السيسي، يبدو أن هذا المشروع أصبح مجرد ذكرى تُذكر في الاجتماعات، مع عدم وجود خطوات فعلية نحو تحقيقه.
الفشل الإداري لنظام السيسي
بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، أُهملت العديد من المشاريع التي بدأها نظام مرسي، بما في ذلك مشروع ربط بحيرة فيكتوريا. على الرغم من تصريحات الحكومة الحالية حول أهمية المشروع، فإن الواقع يثبت أن السيسي يعتمد بشكل أساسي على إنجازات مرسي وحكومته.
تشير التقارير إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 11 مليار دولار، وهي قيمة ضخمة تتطلب التزامًا حقيقيًا من الحكومة المصرية. لكن، ما هو واقع التزام السيسي؟ كيف يمكن الوثوق بنظام تميز بإدارته السيئة وتضخيم الفساد المالي؟
الأهداف الحقيقية للمشروع
بالرغم من أن السيسي يحاول الترويج للمشروع كجزء من رؤية مستقبلية لمصر، فإن هناك شكوكًا كبيرة حول نوايا الحكومة الحالية. هل المشروع يهدف حقًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، أم أنه مجرد وسيلة للسيطرة على مصادر المياه والنيل، خاصة مع تنامي المخاوف من مشروع السد الإثيوبي؟ يُعتبر المشروع أيضًا وسيلة للتأكيد على “هيبة” النظام الحالي، على الرغم من عدم وجود أي إنجازات تذكر على الأرض. من الممكن أن يكون الهدف الحقيقي هو تقديم صورة إيجابية عن الحكومة أمام المجتمع الدولي، بغض النظر عن تحقيق الأهداف المعلنة.
الحاجة إلى الوعي والمحاسبة
الواقع السياسي والاجتماعي في مصر يتطلب وعيًا أكبر من المواطنين بشأن الأمور المتعلقة بمشاريعهم الوطنية. يجب أن يكون هناك ضغط شعبي حقيقي على الحكومة للمطالبة بالشفافية والمحاسبة. مشاريع مثل ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط تحتاج إلى خطة شاملة واضحة، وليس مجرد شعارات تُرفع في الاجتماعات.
في الختام، يبقى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط حلمًا مشتركًا يجب أن يتحقق، ولكن هذا يتطلب نظامًا حكوميًا مسؤولًا وشفافًا، بعيدًا عن الفساد والفشل. على الرغم من الجهود المبذولة للترويج لهذا المشروع، فإن القيادة الحالية، بقيادة السيسي، بحاجة إلى التوجه نحو تحقيق إنجازات حقيقية تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وليس مجرد الاعتماد على إرث محمد مرسي.
* ماذا يعني دخول اتفاقية دول نهر النيل حيز التنفيذ؟
دخلت اتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، المعروفة بـ “اتفاقية عنتيبي”، الأحد 13 أكتوبر حيز التنفيذ بعد ما يقرب من عشر سنوات من المفاوضات التي جرت بين الدول المطلة على نهر النيل.
وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب ما أوضحته مفوضية دول حوض النيل، إلى تحقيق استغلال مشترك ومستدام لمياه النهر بما يخدم مصالح جميع الدول المعنية، مع ضمان استخدام عادل ومستدام لموارد النهر لصالح الأجيال القادمة.
لكن وزير الري والموارد المائية المصري أكد، أن مصر “لن تعترف” بهذه الاتفاقية، قائلاً أن “لا يمكنها التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل“.
في هذا التقرير، سنستعرض ما هي اتفاقية عنتيبي، أسباب رفض مصر والسودان لها، وما يمكن أن تترتب عليه هذه الخلافات من تداعيات؟
ما هي اتفاقية عنتيبي؟
تعد اتفاقية الإطار التعاوني، والمعروفة باسم “اتفاقية عنتيبي”، أول محاولة شاملة لوضع إطار قانوني ومؤسسي يجمع دول حوض النيل. وتحاول “عنتيبي” أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1997، التي تهدف إلى تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية، وتطالب الدول المشاركة في كل حوض بوضع إطار قانوني ملزم لتحديد كيفية استخدام الموارد المشتركة وآليات حل النزاعات المحتملة بينها.
وقد جاءت اتفاقية عنتيبي كبديل لمبادرة حوض النيل التي وُقّعت في عام 1999، والتي كانت تهدف إلى وضع استراتيجية للتعاون بين دول الحوض، بهدف تحقيق المنفعة المشتركة وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
ورغم أهمية هذه المبادرة، إلا أنها كانت مجرد آلية مؤقتة ولم تستند إلى معاهدة قانونية دائمة، مما دفع الدول إلى البحث عن إطار قانوني أكثر ثباتًا واستدامة، وهو ما تحقق في اتفاقية عنتيبي.
و بعد 10 سنوات من المفاوضات، تم توقيع اتفاقية عنتيبي، التي تعد أيضًا نقطة انطلاق للأزمة المتعلقة بـ سد النهضة الإثيوبي. ورغم أنها كانت تهدف إلى تأسيس إطار قانوني مؤسسي لمبادرة حوض النيل، فإن مصر والسودان اعتبرتا الاتفاقية مخالفة للاتفاقيات الدولية القائمة.
بينما صادقت 5 دول على الاتفاقية: إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، رواندا، وكينيا. وفي الثامن من يوليو/تموز الماضي، انضمت جنوب السودان، لتصبح الدولة السادسة المصادقة على الاتفاقية، ما يعني اكتمال نصاب الثلثين من دول الحوض اللازم لتنفيذها. في المقابل، رفضت دول أخرى مثل مصر، السودان، الكونغو، بوروندي، وإريتريا الانضمام إليها.
وتنص المادة 43 من الاتفاقية على دخولها مضمار التنفيذ في اليوم الـ60، الذي يلي إيداع وثيقة التصديق لدى الاتحاد الأفريقي.
وفي يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، واصفًا هذه الخطوة بأنها لحظة تاريخية وتمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو تحقيق الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
لماذا ترفضها مصر والسودان؟
ترفض مصر والسودان اتفاقية عنتيبي، إذ يرونها تمثل تهديدًا لحصصهما التاريخية في مياه النيل، حيث تحدد الاتفاقيات السابقة حصة السودان بـ18.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. وتعتبر الدولتان أن الاتفاقية تقوّض هذه الحصص وتفتح الباب أمام تغييرات غير مقبولة.
في الوقت نفسه، تستمر الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول سد النهضة، حيث يتبادل الأطراف الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المفاوضات التي بدأت منذ أكثر من 10 سنوات.
تعتبر مصر والسودان أن اتفاقية عنتيبي تتعارض مع كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل، ولذلك رفضتا التوقيع عليها إلا بعد تضمين مجموعة من المبادئ الأساسية ومنها:
- ضرورة الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل
- ووجوب الإخطار المسبق عن أي مشروعات تقام على النهر
- عدم تعديل أي من بنود الاتفاقية إلا بإجماع كافة الدول الموقعة، بما في ذلك دولتا المصب (مصر والسودان).
إذ تخشى مصر والسودان من أن تقوم دول المنبع بتنفيذ مشروعات مائية كبيرة قد تستهلك كميات كبيرة من مياه النيل، مما يهدد حصصهما التاريخية.
بالإضافة لذلك، ستعتبر اتفاقية عنتيبي عائقًا أمام أي مفاوضات مستقبلية بشأن هذه الحصص، حيث أنها تغلق الباب أمام أي مفاوضات ممكنة حيال هذه الحصص لهذا السبب، جددت مصر والسودان موقفهما الرافض للاتفاقية، وذلك بعد الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، لتأكيد تحفظاتهما على هذه الاتفاقية.
ما موقف دول المنبع من الاتفاقية؟
تستند مصر والسودان في موقفهما الرافض لاتفاقية عنتيبي إلى اتفاقية 1959، التي وُقعت بين الدولتين فقط باعتبارهما الدولتين المستقلتين الوحيدتين في حوض النيل آنذاك. لم تشارك في تلك الاتفاقية دول أخرى من حوض النيل، مثل تنزانيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، وكينيا، لأنها لم تكن قد نالت استقلالها بعد. حصلت هذه الدول على استقلالها في فترة ما بين 1962 و1963.
حينها كانت الاتفاقية مدفوعة بمشاريع مائية كبيرة خططت لها الدولتان. فمصر كانت تستعد لبناء السد العالي، بينما كانت السودان تخطط لبناء سد الروصيرص. وبموجب الاتفاقية، تم رفع حصة السودان من مياه النيل من 4 مليارات متر مكعب إلى 18.5 مليار متر مكعب، في حين حصلت مصر على 55.5 مليار متر مكعب.
على الجانب الآخر، تدعم إثيوبيا بشكل قوي اتفاقية عنتيبي، وتشاركها هذا الموقف الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاقية.
وفي تعليق على بدء تنفيذ الاتفاقية، كتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على منصة إكس، الأحد، قائلاً: “إن 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 يمثل تتويجا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلما تاريخيا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل”. ودعا آبي أحمد الدول غير الموقعة إلى الانضمام إلى “عائلة النيل، للتمكن معا من تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي“.
إذ ترى دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، أن الاتفاقيات التي عُقدت قبل استقلالها، مثل اتفاقية 1959، غير ملزمة لها.
إذ تعتبر هذه الدول أن تلك الاتفاقيات كانت من صنع القوى الاستعمارية ولم تأخذ في الاعتبار مصالح دول حوض النيل التي لم تكن مستقلة في ذلك الوقت. ولذلك، ترفض هذه الدول الاعتراف بتلك الاتفاقيات، وتؤكد أنها لم تنضم إليها بعد استقلالها.
كما ترى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي أن الاتفاقيات السابقة منحت مصر هيمنة مطلقة على مياه النيل دون مراعاة احتياجات دول الحوض الأخرى. وتعتبر أن هذه الاتفاقيات لم تأخذ في الحسبان حقوقها في استغلال مياه النيل لتنميتها الحالية والمستقبلية.
وترتكز مصر في موقفها من اتفاقيات مياه النيل على حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1989، الذي أقر بأن اتفاقيات المياه لا تختلف عن اتفاقيات الحدود، وبالتالي لا يجوز تعديلها بشكل أحادي أو من دون موافقة الأطراف المعنية.
أبرز الاتفاقيات السابقة لاتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل:
اتفاقية 1902: وُقعت بين بريطانيا، بصفتها ممثلة لمصر والسودان، وبين إثيوبيا. نصت الاتفاقية على عدم إقامة إثيوبيا لأي مشروعات على منابع النيل تؤثر على تدفق مياه النهر.
اتفاقية 1929: عقدت بين مصر وبريطانيا (التي كانت تمثل السودان، أوغندا، كينيا، وتنزانيا). تضمنت الاتفاقية شرطًا بعدم القيام بأي مشروعات على النيل أو روافده من دون موافقة مسبقة من مصر، وذلك لضمان عدم إنقاص حصتها المائية.
اتفاقية 1959: جاءت مكملة لاتفاقية 1929 بين مصر والسودان، وهدفت إلى توزيع كامل لمياه النيل بين البلدين. نصت على تخصيص 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان. هذه الاتفاقية ترفضها بقية دول حوض النيل لأنها لم تكن طرفًا فيها.
على مر العقود، لم تتوقف المشاورات عند اتفاقية 1959 بين دول حوض النيل حول سبل تحقيق التعاون المستدام بهدف الحفاظ على حقوق المياه وضمان استخدامها العادل. تمثلت أبرز المبادرات في:
مبادرة هيدروميت (1967): أطلقت هذه المبادرة بسبب الارتفاع الكبير في مستوى مياه بحيرة فيكتوريا في أوائل الستينيات، مما تسبب في فيضانات وأضرار كبيرة.
شاركت معظم دول الحوض في المبادرة باستثناء إثيوبيا، إلا أن بعض الدول شككت في نوايا مصر والسودان فيما يتعلق باستخدام هذه البيانات في التخطيط المستقبلي، مما أثر على الثقة بين الدول.
مبادرة أندوغو (1983): كانت مبادرة غير رسمية اقترحتها مصر، هدفت إلى مناقشة قضايا المياه والزراعة وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين دول الحوض.
انضمت إليها السودان وأوغندا وعدة دول أخرى، بينما بقيت كينيا وإثيوبيا في موقع المراقب. ومع ذلك، فشلت المبادرة في تلبية توقعات الدول المشاركة بسبب غياب اللوائح الملزمة واتهام مصر بعدم الالتزام بها.
المبادرة الانتقالية (1993): بعد فشل مبادرة أندوغو، تم إنشاء لجنة تيكونيل لتعزيز التعاون الفني وحماية البيئة. شاركت فيها مصر ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
كانت تهدف إلى أن تكون مبادرة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، إلا أن تركيزها على الجوانب الفنية فقط، كما حدث في هيدروميت، أدى إلى عزوف بعض الدول الأخرى عن الانضمام.
في عام 1997، أطلقت لجنة النيل شراكة مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، الذي تم تكليفه بقيادة وتنسيق أنشطة المانحين لدعم إنشاء آلية استشارية على مستوى الحوض.
مبادرة حوض النيل (1999): وفي عام 1998، وافقت اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل على مقترحات تتعلق بـ “المبادئ التوجيهية لسياسة مبادرة حوض النيل” و”خطة العمل لإنشاء مبادرة حوض النيل”. ونتيجة لذلك، تم الإعلان رسميًا عن مبادرة حوض النيل في فبراير/شباط 1999، حيث وقعت عليها 9 من دول الحوض. إلا أن هذه المبادرة كانت مؤقتة ولم تستند إلى معاهدة قانونية دائمة.
وفقًا للتقارير، كانت مساحة الاتفاق في مبادرة 1999 واسعة، حيث تم التوافق على أكثر من 90% من بنود الاتفاقية.
ومع ذلك، برزت الخلافات بشكل واضح خلال اجتماع كنشاسا عام 2009، الذي شهد تصاعد التوترات وفشل جميع اللجان الفنية والوزارية في التوصل إلى حلول شاملة.
فكانت أهم تحفظات مصر والسودان حول ضرورة الحفاظ على حصصهما التاريخية من مياه النيل، أو إدراج بند يضمن عدم اتخاذ أي قرارات جوهرية دون موافقتهما.
في المقابل، تحفظت إثيوبيا بشأن شرط الإخطار المسبق وتعريفات الأمن المائي، بينما دول المصب الأخرى رفضت بشكل قاطع التشاور المسبق حول المشروعات الجديدة على مجرى النيل. هذه النقاط الخلافية عمقت الفجوة بين الأطراف وأصبحت عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق شامل.
تداعيات دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، أكدت مصر والسودان أن مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل بشكل شامل، ودعت الدولتان إلى إعادة توحيد الصفوف ضمن مبادرة حوض النيل، وأعلنت أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما.
كما شدد البيان على التزام الدولتين بالتعاون مع دول الحوض وفقًا للمبادئ الدولية التي تضمن المنفعة المشتركة دون التسبب في أضرار لأي طرف.
تأتي الاتفاقية في وقت، تتصاعد فيه التوترات بشكل مستمر منذ أكثر من عقد بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الملء والتشغيل.
لكن إثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، وهو ما تطالب به مصر لضمان استمرار تدفق حصصها المائية، خاصة في أوقات الجفاف. في المقابل، ترى إثيوبيا أن السد يمثل عنصرًا أساسيًا في جهود التنمية عبر توليد الكهرباء، وتؤكد أنه لن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لعدة سنوات حتى استئنافها في عام 2023.
في ديسمبر 2023، عُقدت الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا، مصر، والسودان في أديس أبابا، إلا أن القاهرة أعلنت بعدها فشل المفاوضات بسبب ما وصفته بـ رفض إثيوبيا لأي حلول وسط. وأكدت مصر مجددًا تمسكها بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
منذ 2020، تشهد عمليات ملء السد السنوية رفضًا مصريًا مستمرًا، دفع القاهرة إلى رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2021.
*”ضمن عمليات بيع الشركات المصرية” أرلا فودز الدنماركية تتقدم بعرض لشراء “دومتي” بـ 8.9 مليار جنيه
في خطوة ضمن مسار عمليات الاستحواذ على الشركات المصرية، قدّمت شركة “أرلا فودز” الدنماركية، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة “لورباك”، عرضاً لشراء غالبية أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”.
وتضمن العرض دفع 31.48 جنيه مصري للسهم الواحد، ما يمثل علاوة بنسبة 74% على سعر الإغلاق الحالي للسهم البالغ 18.03 جنيه، ليتم تقييم “دومتي” عند حوالي 8.9 مليار جنيه مصري (183 مليون دولار).
ووفقاً للبيان الصادر عن “أرلا”، فإنه من المتوقع أن تستمر عائلة الدماطي، الملاك الحاليين لـ “دومتي”، كمساهمين في الشركة، مع بقاء محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي.
وقد أكّد الدماطي، عبر منشور على صفحته في “فيسبوك”، أن الشركة تلقت بالفعل هذا العرض وأن مجلس الإدارة سيناقش العرض في اجتماعه القادم، مشيراً إلى أن عائلة الدماطي ستظل جزءًا من الشركة بغض النظر عن نتيجة الصفقة.
من جهته، صرّح كيم فيلادسن، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “أرلا فودز”، أن السوق المصرية كبيرة وواعدة في قطاع الألبان، وأن “دومتي” تُعد شركة رائدة في هذا المجال، مما يجعل الاستحواذ جزءًا من استراتيجية “أرلا” للتوسع في مصر.
* حياة العمال في المحاجر .. كفاح يومي بين الموت والفقر
تحت أشعة الشمس القاسية في صحراء المنيا، يجابه العمال خطر الموت يوميًا من أجل تأمين لقمة العيش.
تتجاوز أعدادهم 200 ألف عامل، يتنفسون الغبار وينحتون الصخور بجهودهم المضنية في ظروف غير إنسانية،
بينما تُغيب عنهم التأمينات الاجتماعية والصحية، وتظل أحلامهم في الحصول على حقوقهم وحياتهم في خطر مستمر.
هؤلاء العمال الذين لا تتجاوز أجورهم 300 جنيه يوميًا، يدفعون ثمن شجاعتهم بصحتهم وأرواحهم، ليظلوا مهددين بإصابات خطيرة، وكأنهم يعيشون على حافة الموت.
عمال المحاجر، شريحة من المجتمع تعاني من نقص الحماية والرعاية، يعملون في مهنة قاسية لا تعترف بالضعيف أو المريض.
يرتبط العمل في هذه الصناعة بمخاطر جسيمة، حيث يهددهم الغبار الكثيف وآلات القطع الحادة والمعدات الثقيلة.
في غياب التأمينات اللازمة، يصبح العامل ضحية للأمراض والإصابات، دون أي عون أو تعويض من أصحاب العمل الذين يسعون لتحقيق مكاسبهم على حساب صحة العمال.
أحد هؤلاء العمال، حسن أبو علي، يحكي عن تجربته اليومية في عالم المحاجر، حيث يبدأ عمله منذ الفجر حتى الظهيرة.
رغم أنه خريج جامعة، إلا أنه لم يجد فرصة عمل في أي مجال آخر، فوجد نفسه مضطراً للعمل في أحد المحاجر لتأمين مستلزمات أسرته.
ويصف العمل بالمحاجر بأنه من أصعب المهن التي تتطلب بذل جهد كبير تحت ظروف قاسية، حيث يكافح العامل من أجل الحصول على لقمة العيش، رغم كل المخاطر المحيطة به.
يؤكد حسن أن 300 جنيه التي يتقاضاها يوميًا لا تعكس المخاطر التي يواجهها، فكل لحظة قد تحمل الإصابة أو الموت.
لا توجد أي مظلة تأمينية تحمي العامل في حال حدوث إصابة، ولا يجد الدعم من أصحاب العمل الذين يهتمون فقط بمصالحهم. ومع تزايد حوادث الإصابة، تصبح حياة العمال كفاحًا مستمرًا بين الأمل واليأس.
يحدثنا محمد أبو فتحي، وهو عامل آخر في أحد المحاجر، عن تفاصيل يومه المرهق. يبدأ العمل من الساعة الرابعة صباحًا، ويستمر حتى الواحدة ظهرًا، ثم تتجدد نوبات العمل في الفترة المسائية.
ومع استمرار العمل تحت ظروف صعبة، يبقى العامل متخوفًا من التعرض للإصابات. يروي أبو فتحي كيف فقد شقيقه أحد العمال الذي تعرض لإصابة خطيرة
ولم يتلق أي دعم من صاحب المحجر. وبعد محاولات للحصول على تعويض، كان مصيره أن يتحمل تكاليف العلاج بمفرده، بينما أصحابه يستمرون في تجاهل مصيره.
مخاطر العمل في المحاجر لا تقتصر على الإصابات الناتجة عن الآلات الحادة، بل تشمل أيضًا المخاطر الكهربائية.
الكابلات المكشوفة تهدد حياة العمال، مما يزيد من حدة الخطر الذي يواجهونه يوميًا. وبالرغم من تحذيرات النقابة والجهات المعنية،
يظل أصحاب المحاجر مستمرين في إهمال سلامة العمال، مهددين إياهم بفقدان وظائفهم إذا ما حاولوا المطالبة بحقوقهم.
تتضاعف مأساة العمال في المحاجر مع قلة الوعي العام بحقوقهم. تعاني هذه الفئة من عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الصحية، مما يجعلهم عرضة للأمراض والإصابات دون أي مساعدة.
النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم تبرز كممثل لهم، لكن التحديات التي تواجهها تبقى كبيرة.
يطالب رئيس النقابة حسن سمارة بتحسين الأوضاع وتوفير الحماية اللازمة للعمال، مؤكدًا أن هذه الفئة بحاجة ماسة للرعاية والدعم.
وفي الوقت الذي تعقد فيه اجتماعات لمناقشة مشكلات العاملين في المحاجر، يبقى الواقع على الأرض مؤلمًا.
تركز النقاشات على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بسّن التقاعد، حيث يتقاعد العمال عند 55 عامًا رغم طبيعة العمل القاسية التي تتطلب المزيد من الجهد والوقت. تأتي المناشدات من نواب البرلمان لتعديل القوانين، لكن دون استجابة فعالة.
عند النظر إلى الأرقام، نجد أن عدد العمال غير المنتظمين في المحاجر يتراوح بين 150 إلى 200 ألف عامل، بينما يوجد 12.5 ألف عامل مسجلين في النقابة.
يعيش هؤلاء العمال في ظروف قاسية، بلا تأمينات ولا دعم، مما يجعل حياتهم على حافة الخطر. هؤلاء الذين ينحتون في الصخور من أجل لقمة العيش، يحتاجون إلى وقفة جادة من الجهات المسؤولة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية.
ويجب أن تتضاف الجهود من قبل النقابات والجهات الحكومية لتحسين ظروف العمل في المحاجر وتوفير الحماية اللازمة للعمال.
فهم لا يستحقون أن يعيشوا في خوف دائم من الإصابات والأمراض، بل يجب أن يتمتعوا بحقوقهم كأفراد يعملون بجد لتأمين مستقبل أسرهم.
إن إهمالهم وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم هو جريمة في حق الإنسانية، ويجب على المجتمع بأسره أن يتحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء العمال الذين يقاتلون من أجل البقاء.
 marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية