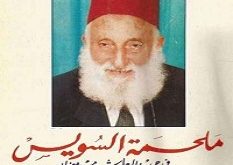البديل السياسي لدى التيارات الإسلامية المعاصرة وفقه التغيير
الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي
الجزء الأول : البدائل السياسية لدى مفكري الصحوة الإسلامية المعاصرة
مقدمة لا بد منها:
يعرض على شباب الصحوة الإسلامية المعاصرة حاليا في بعض المؤلفات والصحف وشعارات بعض الثورات نظام للحكم يعدونه بديلا للنظم القائمة في بلاد المسلمين، أطلقوا عليه مصطلح ” الخلافة على منهاج النبوة”، إلا أن هذا البديل في جوهره ومبناه وواقع تنزيله شكلا وموضوعا لا علاقة له بالنظام السياسي الإسلامي الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه على أساس القرآن والسنة. بل هو نظام حكم فردي استبدادي تسلطي أسسته الملوكية العربية، ونظر له الماوردي، لا علاقة له بأحكام الإسلام ونظامه السياسي.
في هذا الإطار ينبغي فهم هذه الدراسة كيلا يستمر استغفال الشباب الإسلامي المعاصر والتمويه عليه بنظام استبدادي يطلقون عليه كذبا على الله وعلى الناس “الخلافة الإسلامية”.
نص الدراسة:
في مستهل الصحوة المعاصرة ،كان نظام الحكم الإسلامي في تصور رفاعة الطهطاوي ( 1216 – 1290 هـ / 1801 -1873 م ) فرديا استبداديا ، يحمل ملامح من فقه الماوردي . وكان العمران البشري في رأيه محتاجا إلى قوة حاكمة هي الملك، وقوة محكومة هي الشعب.
والمُلك في نظره وظيفة حضارية وتشريعية وتنفيذية لا تستغني عنها الأمة في تدبير مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي إجراء القوانين والأحكام وحفظ الشريعة . وشخص المَلِك مجعول على الأمة من الله . وظيفته النظر في الكليات السلطوية ، التي تنتظم اختيار الوزراء والمسؤولين، الذين هم الوسطاء بين المَلك ” الطبيب ” ، وبين الرعية ” المرضى ” . إلا أن دور هؤلاء الوسطاء استشاري فقط ؛ لأن القرار بيد المَلك الذي لا يجوز أن يُسأل ، وضميره فقط هو الذي يراقبه ويحاسبه.
وأهلية المُلك ليست لكل أحد ؛ لأنها في طبقة مخصوصة كما في الفلسفة اليونانية . والوزارة لا تصلح إلا لأهلها الذين خُلقوا لها . والنظام الملكي وراثي ، فإن لم يوص السابق للاحق اختار أهل الحل والعقد من يحكم البلاد طبقا لنظرية الماوردي . والخروج على الحاكم تظلما أو تمردا لا يجوز ، ولو كان فاسقا أو جاهلا أو معتديا ، وهو ما ذهب إليه أغلب الفقهاء .
أما جمال الدين الأفغاني ( 1254 – 1314 هـ / 1838 – 1897 م ) ، فيرى أن الحكم الفردي المطلق رديف الجهل والتخلف . والنظام الشوروي أصلح للأمة . إلا أن الشورى لديه هي الديموقراطية الدستورية، وعلى المسلمين في نظره أن يقلدوا الغرب في هذا المضمار جملة وتفصيلا ؛ لأن هذا سبيل الرشاد – في نظره-.
كذلك محمد عبده ( 1266 – 1323 هـ / 1849 – 1905 م ) ، يرى نقل التجربة الديموقراطية الغربية حرفيا ، أو اختيار أي منهج يؤدي إلى ما يؤدي إليه نظام الحكم في الغرب . محاولا المزاوجة بين نظرية الماوردي وبين النظام البرلماني الحديث، بأن تختار الأمة طائفتين، إحداهما على علم بحدود الشرع ، هي ” أهل الرأي ” أو ” أهل الحل والعقد ” لمساعدة الحاكم ملكا كان أو رئيس جمهورية ، بالنصيحة والنصرة والشورى، والثانية من نواب يمثلون الشعب إقليميا ومهنيا لوضع مختلف التشريعات والقوانين .
أما عبد الرحمن الكواكبي ( 1271 – 1320 هـ / 1855 – 1902 م) ، فقد شنّ هجوما شرسا وموفقا على الاستبداد ، وتتبع بالدراسة جذوره في النفس والمجتمع والدولة ، وكشف نتائجه المهلكة للحرث والنسل . إلا أن البديل السياسي لديه بقي في إطار النظام الملكي المطلق، الذي تُخَفَّف وطأة استبداده بتعيين فئة من الحكماء هم ” أهل الحل والعقد ” ، بدونهم لا تنعقد الإمامة في نظره . ولهم حق مراقبة الحاكم ومحاسبته ، وهم بمثابة مجالس للنواب ، أو للأسرة الحاكمة ، أو للأعيان ، أو شيوخ القبائل ، على غرار ما كان من أمر ” مجالس الحكماء ” لدى البيتين الأموي والعباسي مما ساعد على استقرارهما واستتباب أمنهما .
ويرى الشيخ محمد رشيد رضا ( 1282 – 1354 هـ / 1865 – 1935 م ) أن الحكم في الإسلام للأمة ، وشكله ديموقراطي ، ورئيسه الإمام أو الخليفة . وعليه أن يتقيد بالشريعة والدستور والقوانين التي يضعها مجلس للنواب مؤلف من مسلمين وغير مسلمين ، لأن مشاركة غير المسلمين في الشورى واستنباط الأحكام والقوانين، من مصالح المسلمين . والمصلحة هي الأصل في الأحكام الدنيوية ، وهي مُقدَّمة على النص عند بعض الفقهاء . ولا يُشترط الاجتهاد في هؤلاء النواب على رغم أنهم في نظره ينصبون الأئمة ، ويعزلونهم إذا اقتضى الأمر ذلك . ولعل آراء الشيخ رشيد رضا هذه متأثرة بواقع مجتمعه الذي تمثل فيه المسيحية نسبة عددية كبيرة لا بأس بها.
أما الشيخ علي حسن عبد الرزاق ( 1305 – 1386 هـ / 1888 – 1966 م ) فقد ذهب في كتابه ” الإسلام وأصول الحكم ” إلى إنكار دور الإسلام في تنظيم شؤون الحكم ، وادعى أن الشريعة الإسلامية مجرد عبادات روحية لا علاقة لها بشؤون الدولة والدنيا . وأن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان غامضا مبهما، وأنكر أن تكون حكومة الراشدين حكومة دينية ، وكان هذا منه خدمة لأهداف السياسة الاستعمارية الإنجليزية والعالمية في المنطقة ، وعملها على الحيلولة دون عودة الأمة إلى وحدتها بعد إلغاء الخلافة العثمانية . وصادف ذلك أن مَلك مصر كان يطمح بدوره إلى منصب الخليفة ، فغضب على الشيخ علي عبد الرزاق وسحب منه شهادة الأزهر . ثم إن هيئة كبار العلماء عقدت له مجلسا تأديبيا برئاسة شيخ الأزهر؛ فثبت لديهم انحرافه الفقهي وعلاقته بأعداء الأمة ، وصدر الحكم بناء على ذلك بمحو اسمه من سجلات الأزهر والمعاهد الأخرى ، وطرده من وظيفته ، وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة دينية أو غير دينية .
ثم بعده ظهر الدكتور عبد الرزاق السنهوري كبير خبراء القانون المدني في عصره ( 1312 – 1391 هـ / 1895 – 1971 م ) ، فبدا أثر الثقافة الفرنسية والاستشراق اللذين تشربهما أثناء دراسته بفرنسا واضحا في تصوره لنظام الحكم في الإسلام ، لاسيما في كتابه ” فقه الخلافة وتطورها ” ؛إذ صنّف النظام السياسي الإسلامي صنفين :خلافة صحيحة هي حكومة الراشدين ، وخلافة ناقصة هي خلافة بني أمية وبني العباس ؛ على غرار تصنيف بعض الفقهاء قبله ، مما له أصل في تصنيف أفلاطون للأنظمة السياسية ثلاثة أصناف : حكومة مثالية السيادة فيها للعقل ، والمَلك يختص فيها بالمعرفة التامة دون شعبه ، وحكومة ناقصة لها من القوانين ما يضبطها ، وحكومة جاهلة لا مَلك لها ولا قانون . كما ذهب إلى أن الشريعة لا تفرض اطلاقا شكلا معينا لنظام الحكم وهو ما يكاد يقترب فيه من الشيخ علي حسن عبد الرزاق.
أما منهج التدبير في الخلافتين الصحيحة والناقصة عند السنهوري ، فلم يخرج فيه عما ذهب إليه الماوردي في أحكامه السلطانية ومن سار على نهجه من الفقهاء ، لاسيما فيما يتعلق باختيار الإمام واستدامته أو عزله ، ومحدودية مجالس الشورى وعدم إلزامية آرائها ، وعضويتها المنحصرة في أعيان الأسرة الحاكمة وشيوخ القبائل وكبار الأغنياء والموالين من الفقهاء.
كما تجلى تأثره بالثقافة الغربية العلمانية عندما رأى تعذر إقامة حكم إسلامي في العصر الحديث يجمع للمسلمين أمري دينهم ودنياهم . واقترح بديلا لذلك إنشاء منظمتين دوليتين ، إحداهما للتعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي بين الدول الإسلامية يُطلق عليها ” عصبة الأمم الإسلامية ” على غرار ” عصبة الأمم ” لدى الدول الأوربية.
والمنظمة الثانية دينية لتنسيق النهوض بالشريعة الإسلامية وتشجيعه . وبهذا الاقتراح ساهم في إبعاد المسلمين عن المطالبة بوحدتهم السياسية والدينية في إطار دولة الخلافة ، وعمل على تكريس الاتجاه العلماني الخاص بفصل الدين عن الدولة وهو ما كان يسعى إليه الاستعمار الغربي حينئذ .
ومن الغريب أن بريطانيا كانت أول المستجيبين لرأي السنهوري ، المسترشدين بنصحه ؛ فأنشأت أول منظمة إقليمية سنة 1945 هي ” الجامعة العربية “. ثم في سنة 1969م دعت هذه الجامعة العربية إلى إنشاء منظمة أوسع ، تضم المسلمين عربا وغير عرب ، فتكونت منظمة ” المؤتمر الإسلامي ” ؛ كما عملت المملكة العربية السعودية على تأسيس ” رابطة العالم الإسلامي “.
وفي ظل منظمتي ” الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ” نسي المسلمون أمر الوحدة الإسلامية سواء في ظل الخلافة الصحيحة أو الخلافة الناقصة ، وعرفوا على يد الغرب والصهيونية العالمية كل ضروب الذل والهوان والهزيمة والخضوع الإرادي الرسمي للأجنبي .
أما الشيخ أبو الأعلى المودودي ( 1321 – 1399 هـ / 1903 – 1979 م ) ، فيرى أن النظام السياسي الإسلامي يسبقه حتما قيام مجتمع إسلامي حق ، تنبثق منه تلقائيا الخلافة الراشدة التي يدبرها إمام يختاره المسلمون ويطيعونه ، ويقيم فيهم أمر الإسلام وينشر بينهم العدل . لأن الدولة الإسلامية ـ كما يقول في ” منهاج الانقلاب الإسلامي ” ـ بمثابة الثمرة من الشجرة ، فإن طابت الشجرة طابت الثمرة . ولذلك لم يرحب بانفصال باكستان عن الهند ؛ لأن ذلك في نظره ليس الطريق الطبيعي لقيام نظام الإسلام السياسي .
وهذا التبسيط للقضية برغم فضل صاحبه وصدقه وجهاديته ، لا يعدو أن يكون خيالا بعيد المنال ، وإلغاء لقضايا واقعية تتعلق بمعضلات الإعداد والتأسيس والتنظيم والتخطيط والبناء والحماية ، لكل مراحل العمل من أجل إقامة دولة الإسلام . كما أنه في نهاية المطاف لا يتجاوز محاولة تأسيس نظام حكم فردي ، ضمانات العدالة فيه مجرد ورع الخليفة وزهده ، وتقوى الرعية وانضباطها وسلوكها القويم . مما لا يغني مطلقا عن ضرورة توضيح طبيعة النظام ومناهج إقامة مؤسساته وضمانات استمرار سيره سويا رشيدا .
نفس التوجه تقريبا ، نجده لدى سيد قطب ( 1324 – 1387 هـ / 1906 – 1966 م )، في كتابه ” معالم في الطريق ” إذ يرى ضرورة استنبات المجتمع الإسلامي الحق أولا ، بدءاً بالخلية التأسيسية التي تقيم أمر الإسلام في النفس والأسرة والمعاملة اليومية ، تماسكا مع الصادقين ، ومفاصلة شعورية للجاهلية ، إلى أن يتحول كل فرد فيها قرآنا يمشي على رجلين . فإن قام المجتمع الإسلامي أثمر الحكومة الإسلامية خلافة على نهج النبوة . ولكنه لم يبين طبيعة هذه الحكومة شكلا ومضمونا ، تنظيما وتدبيرا ، على نهجه في التحليل والجدل ، ورأيه في أن الإسلام لا يُسأل عن واقع ليس من صنعه ، ولا تُرقع به أنظمة ليست على نهجه ، إلا أن تُقام ركائز العقيدة بأرض الواقع متكاملة ، على قاعدتي : ” طبقوا الإسلام أولا ثم اسألوه عن الواقع الذي أنشأه ” ، و ” خذوا الإسلام جملة أو دعوه ” .
أما الدكتور حسن الترابي ، فهو يدعو في كتابه ” نظرات في الفقه السياسي ” إلى تجاوز المشاحة في المصطلحات الوافدة على المسلمين من الغرب ، واستعمالات الألفاظ ذات الأصول غير العربية وغير الإسلامية . إذ لا حرج في نظره على المرء وهو يتكلم ( من موقع عزة ثقافية ، وفي سياق يُحترز به من الخلط أن يستعمل كلمة ” GOD ” مُعَرَّفَةً بالحرف الكبير ، إشارة إلى الله ) ؛ كما يُعرِّض بالمسلمين الذين يرفضون ذلك بكون ( كثير من المسلمين الأوربيين الجدد إذا قاموا في بيئة اشتراكية أو تثليثية يحترزون من استعمال ” GOD ” ؛ لأنها تنصرف عند السامعين إلى فكرة التثليث ، فتوحي بإله يجوز في حقه ذلك كله ، مما يستحيل في حق الله ).
والدكتور الترابي فيما ذهب إليه ، يغفل عن حقيقة من حقائق الإيمان ، هي الركن الثالث من أركان التوحيد ، بعد ركني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ، هي توحيد الصفات . أي أن الله تعالى ، لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم ، ) ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ( -الأعراف 180 – . ولم يرِدْ قطعا وصف الله عز وجل بلفظ ” GOD ” . كما أن قابلية هذا اللفظ لصيغ الجمع والتأنيث والتذكير راجعة إلى طبيعة الدين لدى الغرب. وهو كما نعلم مؤسس على أصول وثنية يونانية ، لديها آلهة ذكور مثل “جوبيتر ” ، وآلهة إناث مثل ” أفروديت ” ، وتعتقد أن في السماء آلهة متعددين يسيرون الكون ، كما أن المسيحيين يؤمنون بتعدد الآلهة ( الأب والابن والروح القدس ) ، ويعدّون مريم البتول عليها السلام إلهة . فتأنيث الألوهية وتذكيرها وجمعها من صميم ديانتهم .
إن الترابي يصل بهذا الجنوح في التفكير إلى هدف رسمه لنفسه ، هو محاولة الإقناع بقبول لفظ ” ديموقراطية ” مصطلحا إسلاميا لنظام الحكم ، وتبني المناهج السياسية الغربية شكلا ومضمونا ، و ( مصادرتها لصالح الإسلام ) ، و ( غلبة أهلها عليها ). (فالإسلام الناهض المشع اليوم يستصحب فتحا متمددا لغويا . إذ تحيى وتعمر المعاني في الكلمات التقليدية للإسلام ، ويتسنى له أن يستوعب الكلمات الأجنبية ، ويغلب عليها أهلها ، ويضفي عليها الظلال الإسلامية ، ويسخرها لعبادة الله سبحانه وتعالى … ومن هنا يتمكن المسلمون مثلا إن قاموا بقوة وثقة وتوكل ، أن يصادروا كلمة ” ثورة” وكلمة ” ديموقراطية ” وكلمة ” اشتراكية ” لصالح الإسلام … ، أما وقد تجاوزنا غربة الإسلام ، وغلبة المفاهيم الغربية بكل مضامينها وظلالها ، فلا بأس من الاستعانة بكل كلمة رائجة تعبر عن معنى ، وإدراجها في سياق الدعوة للإسلام ، ولفِّها بأُطر التصورات الإسلامية حتى تُسلم لله ) .
كما أن الشورى عند الترابي من أصل الدين ، أي من صميم العقيدة وليست من الفروع ؛ وما دامت الشورى في نظره هي الديموقراطية ، فالديموقراطية ـ إذن ـ من أصل الدين وعقيدته.
وغني عن البيان تهافت هذه الآراء وخروجها عن النهج الرشيد السوي في التفكير. فالمصطلحات الإسلامية ليست مجرد كلمات تقليدية كما وصفها الترابي ، بل هي ألفاظ دينية نقلها القرآن الكريم والسنة النبوية من معناها اللغوي إلى مفهومها العقدي والتشريعي ، فاكتسبت بذلك سمتا وحرمة خاصين . كما أن الإسلام متكامل المصطلحات الدينية ، ولا تعاني مفرداته من خواء أو موات تحتاج معهما إلى أن تعْمُرَ وتحيى باستيراد ” قطع غيار ” أجنبية . وليس في عملية استيراد المصطلحات الغربية أي غلبة لأهلها عليها أو مصادرة لها ، لأن أهلها أنفسهم يرغبون في ذلك ، ويشجعون عليه ويعدونه خدمة جليلة لأهدافهم في الهيمنة والاستعمار والتنصير .
إن الدكتور الترابي مهما حاول تغليف هذا الاقتراح ، ولفّ هذه المصطلحات الغربية بصباغ الإسلام ، وحشرها بأسلوبيته الإنشائية الرشيقة في السياق الإسلامي، فلن يؤدي هذا المنهج في التفكير لديه ، إلا إلى تغريب مفاهيمنا ومصطلحاتنا الدينية، ومصادرة الغرب لأمتنا وبلادنا ومقدساتنا . بل قد يُستدرج بعضنا ـ والعياذ بالله ـ إلى المطالبة بأن نغلب الغرب على دينه فنعتنقه ، وعلى لغته فنتخلى عن لغتنا . وكأننا لم نغلبهم بعد على ما لديهم من فساد وميوعة وتحلل ، ولم نصادر ما عندهم من انحراف وشذوذ ودعارة .
ولعل الدكتور عدنان النحوي أول من خصص للشورى مصنفا تجاوز عدد صفحاته سبعين وستمائة ، عنوانه ” الشورى وممارستها الإيمانية ” . وهي منه خطوة رشيدة تحتاج إلى مناصحة ومتابعة وتطوير . وقد شرح في كتابه الصفة الإيمانية للشورى ، وبيّن أنها عصمة من الاستبداد ، وأن غياب العقيدة وانفصالها عن الشورى يؤدي إلى تحكم الهوى والتيه والضياع ، وظلام الفتنة وهدير الشيطان ، والممارسات الشوروية الزائفة ، المبنية على الأصابع المرفوعة والأيدي الممدودة . وأن القيادة الإسلامية الرشيدة تحمل خصائصها أولا ثم يُبحث لها عن تسمية ثانية . وما دامت البيعة على قواعد الإسلام وأسسه ، فالسمع والطاعة في المعروف واجبان، سواء لأمير أو خليفة أو رئيس .
و” أهل الرأي ” ، أو ” أهل الشورى ” أو ” أولو الأمر ” ، في رأيه هم العلماء، ويجب أن تتوفر فيهم شروط الإيمان والتقوى والعلم والموهبة والوسع والحلم والأناة والروية والتدبر والقدرة وبسطة الجسم وحسن السلوك والعدالة.
كما استقصى في كتابه أكثر النصوص المتعلقة بالشورى في الكتاب والسنة والآثار. إلا أنه في جميع ما أورد من نصوص واجتهادات ، لم يخرج عن دائرة من سبقه من الفقهاء الذين يرون الشورى حكرا على نخبة خاصة ، اعتمادا منه على حديث رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارمي ، قال : ” أخبرنا محمد بن المبارك ، ثنا يحيى بن حمزة ، حدثني أبو سلمة ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة ، فقال : ( ينظر فيه العابدون من المسلمين ) ” . وهذا الحديث مرسل ومتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية العملية الصحيحة ؛ إذ أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين في الشورى أثناء الاستعداد لملاقاة المشركين في أحد . وقد رُوي الحديث بمعناه في ” مجمع الزوائد ” للهيثمي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ” قلت يا رسول الله ، أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه سنة منك ؟ ” قال : ” تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين و لا تقضونه برأي خاصة ” . وقد أخرجه الطبراني في الكبير ، إلا أن فيه عبد الله بن كيسان ، قال فيه البخاري : ” منكر الحديث “.
كما أن الدكتور عدنان النحوي لم يخرج أيضا عن دائرة الحكم الفردي الذي ليس له من ضمانات الاستمرار إلا ورع الراعي والرعية . فإن ضعُف أو انعدم عمَّ التظالم والفوضى ، وصار الاستبداد سيد الموقف . ونحن نلتمس نظاما شورويا له من المؤسسات والنظم والضوابط ما يضمن استمراره وفعاليته وجدواه ، ويؤمِّن سلامة الأمة وحقوق أفرادها في الحرية والكرامة وتدبير أمرهم ، قرارا وتنفيذا ومحاسبة ، غُرما وغُنما جهدا ومنفعة .
الجزء الثاني :البديل السياسي لدى التيارات الإسلامية المعاصرة وفقه التغيير
في الجزء الأول كان الاكتفاء بما حرره أقطاب الفكر الإسلامي المؤسسون للصحوة المعاصرة من بداية القرن الميلادي التاسع عشر، لأنهم رسموا لها بما كتبوه وصنفوه خط السير الذي لا تكاد تخرج عنه، ولا يكاد يغادره مفكروها اللاحقون، مما هو واضح في مناهج جل الأحزاب الإسلامية المعاصرة في المنطقة العربية والإسلامية، وهو ما أسبغ على أهدافها ظلالا كثيفة وغبشا وترددا وخلطا بين فكر الماوردي الاستبدادي وبين فكر الديمقراطية الغربية العلمانية، مع تغليب لأحدهما حينا أو إجحاف في حقه حينا آخر.
إلا أن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت اكتساح الساحة الإسلامية من طرف اتجاهين وافدين من أقصى فترات الصراع العقدي السياسي، كادا يعصفا بفكر السادة المؤسسين(الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده والكواكبي والسنهوري والمودودي وقطب وغيرهم)، هذان الاتجاهان هما الاتجاه السلفي والاتجاه الشيعي.
أما الاتجاه السلفي فيتجاذبه سياسيا تياران:
تيار السلفية الموالية للأنظمة القائمة بمختلف تسمياته التقليدية والجامية والسرورية وغيرها، ويرى في كل متغلب إماما شرعيا لا يجوز الخروج عليه، ولو كان جاهلا أو فاسق المعتقد والسلوك أو غير قرشي. واستعان رواد هذا التيار في تبرير ما ذهبوا إليه بتأويلات انتقائية ومغالية لبعض نصوص الكتاب والسنة، احتطبوها من آراء الرجال؛ مثل ما ذهب إليه أبو يعلى الحنبلي في كتابه”الأحكام السلطانية”، مما نسبه إلى عبد الله بن عمر من قول “الجمعة مع من غلب” و “نحن مع من غلب” ، أو إلى الإمام أحمد بن حنبل حول شرعية إمامة المعتصم العباسي، وهو أمّي وسكير وفاسق العقيدة يقول بخلق القرآن.
بهذه المرجعية استنبتت السلفية الموالية المعاصرة فتاوى اتخذت متاريس لحماية الاستبداد والظلم والفساد، وقمع انتفاضات المطالبة بالحرية والعدل والكرامة. ثم انقسمت على نفسها إلى فرق أهمها: ما دعي سلفية جامية معتقدها سلفي ولا ترى الخروج على الإمام بأي حال من الأحوال، أسسها الشيخ محمد أمان الجامي الأثيوبي المتجنس سعوديا، وما دعي سلفية سرورية بمعتقد سلفي ذي حركية إخوانية ومنهج يجيز بتأويلات مختلفة إعانة بعض الحكام والتعاون معهم ونصحهم وعدم الخروج عليهم في إطار المقاصد العامة والمصالح المرسلة. من دون أن يقدم أي من الفربقين أو ما تفرع عنهما منهجا سياسيا لنظام الدولة تأسيسا أو تشريعا أو تسييرا.
أما التيار الثاني فهو السلفية الثائرة، أو الجهادية كما أطلق عليها حديثا، وتمثلها حركة جهيمان العتيـبي ومحمد بن عبد الله القحطاني في نهاية القرن الرابع عشر الهجري بمكة المكرمـة، والجماعات الإسلامية المقاتلة في مشرق العالم الإسلامي ومغربه حاليا.
ولئن كان هذا التيار قد تمرد على نظرية “خوف الفتنة” لدى الفقه السني وخرج عليها، فإنه لم يستطع في نظرته السياسية أن يغادر إطار حكم “الفرد” الذي له من ورعه وتقواه وصدقه وإخلاصه ما يملأ به الأرض عدلا كما مُلئت جورا وظلما. وهو ما يُعرف بنظرية “العادل المستبد” ، الذي يتغلب على الأمة بقوة السلاح، أو تنصبه جماعة من “أهل الرأي” ، أو “أهل الحل والعقد” ، قد يتقلص عددها إلى ثلاثة أفراد، أو فردين أو فرد واحد ولو سرا، كما ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين، وكما أسس له الماوردي من قبل.
وكان مآل هذا التيار أن استطاع هدم ما هو قائم، أو خلخلة أركانه؛ ولكنه لم يقدم بديلا إسلاميا للحكم تصورا ونظاما، ونموذجا حضاريا عمليا للحياة.
وأما الفكر السياسي الشيعي المعاصر، فنلاحظ فيه تحرره من قيدين، أحدهما من التراث الإمامي الخاص، هو عقيدة الانتظار التي كبّلته قرونا ومنعته من التطور. وثانيهما من تراث أهل السنة هو قيد “خوف الفتنة” الذي برروا به حكم الاستبداد، وأصلوا به تشريع الرضى بالفساد وعدم جواز الخروج على الظلم .
إلا أن البديل السياسي الذي صاغه الفقه الشيعي المعاصر في نظرية “ولاية الفقيه”، لم يتجاوز نطاق الحكم الفردي المطلق الذي ينوب فيه الفقيه عن الإمام المنتظر، والراد عليه كالراد على الله سبحانه وتعالى. وهو العنوان القيادي الحركي الذي يتولى إدارة المفردات وتدبير القضايا التشريعية والتقنينية للدنيا والآخرة .
ولئن حاول بعض فقهاء هذا الاتجاه، أن يثبتوا أن دور الولي الفقيه في القيادة الفردية لا يلغي دور الأمة التي تُرك لها مجال المشاركة بإبداء الرأي والنصيحة أو بالانتخاب والاستفتاء، فإن صميم العلاقة بين الأمة والولي الفقيه لم تخرج مطلقا عن دائرة الحاكم والمحكوم، وهو ما لدى فقهاء السنة أيضا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم .
ولئن كان الفكر الشيعي قد حاول في هذا العصر أن يؤسس نموذجا للحكم، وينهض بمسؤولية ذلك نهوضا قويا، فإنه في واقع التطبيق لنظرية “ولاية الفقيه” ، لم يتجاوز منهجا سياسيا زاوج فيه بين نظرية الإمامة عند أهل السنة، وبين النظام الجمهوري الديموقراطي الليبرالي، مع مراعاة المشاعر القومية الفارسية والجذور العقدية المذهبية.
ذلك أن “الولي الفقيه” لديهم يختاره مجلس علماء منتخب، وهو ما لدى طائفة من علماء السنة، ترى أن العلماء هم “أولو الأمر” الذين لهم حق تنصيب الإمام . كما أن النظام البرلماني وطريقة صياغة الدستور، وأسلوب تعيين رئيس الجمهورية والوزراء، ليس له من مرجعية إلا الفكر الديموقراطي الغربي. أما اشتراط التشيع والفارسية الأصلية لا المكتسبة في رئيس الجمهورية ؛ فمن صميم الفكر القومي والمذهبي .
وطيلة العقود الثلاثة الماضية برزت في مجال أبحاث الفقه السياسي الإسلامي ظاهرتان :
أولاهما: ظاهرة المؤتمرات والندوات الفكرية التي تنظمها الدول الإسلامية ، عربية وغير عربية، وتحدد لها محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وفقهية ، هدفا معلنا من أجل استصدار توصيات وتزكيات ومواقف لصالح هذه الدولة أو تلك . وأفرزت هذه الظاهرة طائفة من علماء التبرير الجوالين، صدرت عنهم فتاوى متناقضة مضطربة، زكّت جميع أنظمة الحكم القائمة حاليا في بلاد المسلمين بدون استثناء. كما أن هذا اللون من النشاط السياسي لم يستطع أن يمهد ولو لصيغ فكرية تحقق نوعا من التوافق والتلازم بين السلطة والشريعة، ولم يخرج تبعا لذلك عن المفاهيم الفقهية والاجتهادات الكلامية الخاصة بالفقه التراثي التقليدي، برغم استخدامه أساليب ومصطلحات تضاهي”إنشائيات” الحداثيين واليساريين ورطانتهم .
أما الظاهرة الثانية: فتتعلق بالنشاط الإعلامي المسموع والمرئي والمكتوب، الخاص بالفقه السياسي لدى الأمة. وقد ازدهر بشكل كبير بعد ظهور القنوات الفضائية، وشمل ضروبا من الحوار والمناقشة بين علماء ومفكرين من مختلف الأعمار والأقطار والمستويات . وهي ظاهرة إيجابية ، غير أن عدم حيادية وسائل الإعلام التي تنظمها يقلل من جدواها، ويمنعها من أن تصل المدى الذي ينبغي أن تبلغه . ذلك لأن المستفتي فيها له هدف تزكية الجهة التي يمثلها، أو تحقيق مصلحة معينة لها. والمسؤول فيها – المفتي – ، يراعي ألا تُقطع حبال الودّ مع الجهة التي تخاطبه، أو خيوط البثّ التي تنشر رأيه .
كما أن جل مفردات هذه اللقاءات والحوارات إن لم تكن كلها، لا تتعلق بجوهر قضية نظام الحكم، الذي هو التقويم المتكامل الصريح لطبيعة الأنظمة القائمة، والتقديم الواضح الجلي للنظام السياسي الحق. بل تدور في مجملها حول قضايا سياسية ودستورية وفلسفية غائمة مجردة، لا تمسّ لب القضية، وإنما تحوم حول الحمى ولا تقتحمه. مثل قضايا: الفقه المتحرك والفقه الجامد، مسؤولية الإنسان في تقرير مصيره، ومدى مشاركته للحاكم الفرد في إبداء الرأي، ودوره في التدبير العام ضمن حيز يُتصدَّقُ به عليه، وهل البيعة تفويض كامل أو مشروط؟ وطاعة أولي الأمر هل هي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط أم طاعة مطلقة ؟، وهل الديموقراطية حكم إسلامي رشيد أم لا ؟، وهل يجوز في إطار التداول على السلطة أن يرأس الدولة المسلمة شيوعي أو يهودي أو نصراني؟ … الخ .
وقد اكتسبت الدراسات والآراء في هذا السياق صفة الحلقات المفرغة، التي لم تؤد إلى صياغة نظام إسلامي متكامل، بقدر ما ساهمت في خلط أوراق اللعب السياسي وإشاعة الغموض والإبهام، واستدراج كثير من المشاركين بشغب إعلامي متعمد إلى متاهات من الآراء التشطيرية والانتقائية، إن لم نقل الانتهازية التي لم تخرج قط عن إطار حكم للاستبداد، يخفف غلواءه حيز صغير من المشاركة بالرأي . ولم ترق مطلقا إلى مراقي المفهوم القرآني للحكم الرشيد، الذي يجعل أمر المسلمين ملكا لهم، يُسلطون عليه ضمن نظم مؤسساتية وتربوية وعلمية وإدارية وتشريعية وتدبيرية ، تعصم من الجنوح إلى أي شكل من أشكال الاستبداد، حكم فرد كان، أو حكم أقلية حزبية أو طبقية، أو عرقية أو عسكرية أو أمنية .
وبعد، فهذا عرض موجز لأهم ما تمخضت عنه الصحوة الإسلامية المعاصرة، في مجال الفقه السياسي بتعبير العصر، أو فقه الإمامة والأحكام السلطانية بتعبير الفقهاء والمتكلمين. وهو كما رأينا خلاصة تراكمات فكرية وفقهية واجتماعية وسياسية داخلية وتأثيرات أجنبية، عاشها المسلمون ويعيشونها منذ التطبيقات الأولى للحكم الرشيد في المجتمع العربي بصفته الوعاء الأول للإسلام، إلى أن سقطت بلاد المسلمين قاطبة بيد الاستعمار في القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرين، ثم تحررت منه شكليا، بعد أن اصطبغت بكثير من أصباغه الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ولئن كان الفقه السياسي للصحوة المعاصرة غير خاضع لناموس الجمود والسكون والاستقرار، وهذا من مؤشرات الرشد وملامحه، فإنه لم يصل بعد إلى مستوى من الحركية الحقيقية الإيجابية للتطور المنشود، بقدر ما فيه من اضطراب وخلط وغبش في التصور والتوجه لأسباب كثيرة، من أهمها:
– تراكمية التراث البشري المدون، الذي لم تتم دراسته وفرزه وسبره؛ وما حقق منه ونشر كان التقريظ والإعجاب سمة تقديمه، لذا لم ينل حظه من النقد البناء المستند إلى الكتاب والسنة؛ مما يهدد بانتكاسة فكرية في هذا المجال. لأن التراث البشري إما أن يعاد تقديمه بمنهج نقدي موضوعي فيكون منطلقا للتطوير وركيزة للتجديد؛ وإما أن يقدم كمثال نموذجي متكامل يحتذى كما هو واقع الحال، فيكون خطوة إلى الوراء وانتكاسة إلى الخلف، وعرقلة في سبيل التأصيل والتحديث.
– استعجالية بعض الصادقين من التيار الإسلامي، ومبادرتهم بالمصاولة قبل اتضاح الرؤية وتبين الهدف وتكامل البديل .
– انتهازية الوصوليين من المنتسبين إلى التيار الإسلامي، وحرصهم على سرقة جهود الحركة الإسلامية ومقايضة الحكام بها، استجلابا للمناصب والرتب، واحتلابا للمصالح الخاصة والمنافع الآنية .
فما مدى قدرة الصحوة الحالية على الخروج من المأزق ومغادرة النفق، إلى رحاب النظام الإسلامي الرشيد ؟ وماذا ينبغي أن نختار أولا ؟ حاكما أو نظام حكم ؟ خليفة أو نظام خلافة ؟ مدبرا لأمرنا أو نظام تدبير له ؟
وقبل ذلك كله ما هو التصور الرشيد لنظام الحكم في الإسلام ؟
ـ هل هو الخلافة الراشدة في إطارها الأول شكلا ومضمونا ؟
ـ هل هو الملكية الوراثية أموية وعباسية وفاطمية ؟
ـ هل هو النظام الديمقراطي الجمهوري برلمانيا أو رئاسيا، إذا ما طبق الشريعة الإسلامية في الميدان الجنائي ؟
ـ هل هو المزاوجة بين النظم الديمقراطية وبين الاستبداد الفردي ملكيا أو عسكريا أو حكم أجهزة ؟
ـ هل هو نظام ولاية الفقيه مزاوجا بالديمقراطية أو غير مزاوج بها ؟
ـ هل هو نظام غير هذه الأنظمة كلها لم يتبلور بعد في أذهاننا، وله أسس في الكتاب والسنة صريحة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما ؟
للإجابة على هذه الأسئلة وعلى غيرها لا بد من مراجعة نقدية لتاريخنا السياسي جاهلية وإسلاما، تطبيقا سياسيا، وفقها نظريا؛ ومعرفة لأوجه الصواب فيه والخلل، والتأثير والتأثر، ومدى تطابقه أو تعارضه مع الشريعة الإسلامية؛ ودراسته دراسة معمقة تجمع بين الفقه والتاريخ، وتحاكمهما معا إلى القرآن والسنة. ولا تعارض مطلقا في هذا، لأن الفقه هو مجرد فهم المسلم للنصوص، والتاريخ هو عمل المسلم وتصرفه تحت عين النصوص خضوعا لها أو تحايلا عليها أو تمردا ضدها. وبين الفقه والتاريخ عملية إثراء متبادلة، يتأثر التاريخ بالفقه لأن الأحكام الفقهية نافذة في التصرفات، ويتأثر الفقه بالتاريخ لأن كل تصرف يُستصدر له حكم فقهي خاص. ويختلف الفقهاء في حكمهم على التصرفات تبعا لظروف الزمان والمكان والبيئة، وحالات الاختيار والاضطرار والحرية والإكراه. يتطور الفقه والتاريخ معا إلى الأمام، أو يرتكسان معا إلى الحضيض، على قدر علاقتهما بالشريعة الإسلامية ومفاهيمها الحضارية ومبادئها السمحة. فهما فرسا رهـان الحياة الدنيا، لا بد لفهم أحدهما من فهم الآخر. ولئن خفي هذا الارتباط الموضوعي بينهما في بعض المجالات، فهو في المجال السياسي أشد وضوحا.
 marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية